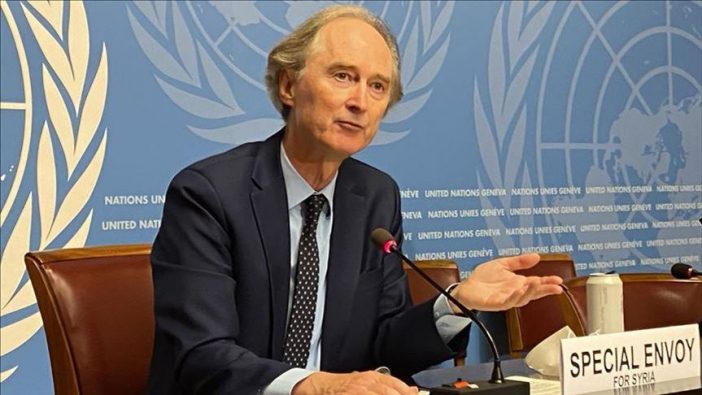مئة عام كاملة مرت على تعيين أول رئيس حكومة في سوريا، بدأت بعهد الأمير سعيد الجزائري بتاريخ 27-9-1918 وتكاد تكون مناصفة بين عهدين: الأول منهما استمر إلى عام 1970، وانتهى بحكومة الرئيس نور الدين الأتاسي، ليبدأ الثاني ويقترب من خمسين عاما في الحكم لعائلة الأسد التي استولت على السلطة إلى يومنا هذا.
يشير موقع رئاسة مجلس الوزراء في سوريا إلى تولّي 77 وزارة مقاليد إدارة البلاد في الخمسين سنة الأولى، ليهبط المؤشر بشكل حاد إلى خمس رؤساء وزارة فقط في عهد الأسد الأب، قادوا تسع حكومات على مدى ما يزيد على ثلاثين عاماً، ليأتي بعدهم ستة رؤساء وزارة في عهد الأسد الابن، إثر وراثته للحكم قبل 19 عاماً.للوهلة الأولى يشعر المتابع لتاريخ سوريا أن الحياة السياسية توقّفت فجأة في البلاد، أو أن الشلل أصابها، وجعل حركتها بطيئة جداً، فالفرق الشاسع بين 77 حكومة في قبل حكم عائلة الأسد، وبين 16 حكومة فقط.يبدأ موقع رئاسة الجمهورية في سوريا عام 1932، ويتعاقب عليه 25 رئيساً خلال أربعين عاماً، ثم في الخمسين عاماً التالية لا يتولّى الرئاسة إلا الأسد الأب ووريثه، وبلا شك فالفرق هنا أكثر بكثير مما هو عليه في موضوع رئاسة الحكومة.على مر تاريخ سوريا تقريباً كان رئيس الجمهورية هو الذي يعيّن رؤساء الحكومات، لكن ما قبل وصول الأسد للسلطة كان هذا التعيين يمر عبر مجلس الشعب الذي يمنح ثقته للحكومة، الأمر الذي تغيّر في دستور 1973 ولم يعد لمجلس الشعب دور في التعيين، لكن أبقى حافظ الأسد لمجلس الشعب صلاحية حجب الثقة ومساءلة الحكومة، ليستخدمها في الحالات التي يريد فيها فضح بعض كبار المسؤولين حين يشعر ببوادر خروجهم عن طاعته، أو بوجود قبول دولي لأحدهم على أنه خليفة محتمل له حال مغادرته للسلطة بطريقة ما.بالنظر إلى هذه الأرقام لا يمكن القول بأن حكم عائلة الأسد أمّن شيئاً من الاستقرار في البلاد، فالأمر لم يكن هكذا، فعلى كلا العهدين حدثت أزمات من جميع الأنواع: اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية، ومشاكل دولية وداخلية كادت تصل بالبلاد إلى الانهيار، كانت بدايتها في ثمانينات القرن الماضي مع جماعة الإخوان المسلمين التي رافقتها أحداث حماة الدامية، فيما الأزمة الحالية مستمرة منذ ثماني سنوات في حرب تسببت بقتل وتشريد واعتقال ملايين السوريين، مع استنزاف للاقتصاد تظهر آثاره الآن في هذه الأزمات الخانقة التي يعاني منها الشعب السوري، وتبدو ماثلة للعيان في أزمة الغاز والبنزين والخبز والكهرباء والمياه، وهي ستتوسع لتشمل قطاعات حياتية أخرى قد يستحيل معها تأمين سبل العيش في أدنى مقوماته.مع أن دساتير سوريا المتعاقبة كانت تمنح الرئيس الصلاحيات الأوسع في كلا السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، ووصل ذلك أوجَه في عهد الأسد الابن الذي يملك قرار حل مجلس الشعب، ويرأس مجلس القضاء الأعلى، وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما إنه هو الذي يعين رئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، وموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، إلا أن تقاليد الحكم يبدو أنها تجعل الرئيس في منأى عن المساءلة والمحاسبة على الأخطاء التي تقع في إدارة البلاد، يمكن أن يستقيل الرئيس لأسباب شخصية مثل استقالة الرئيس الأول محمد علي العابد عام 1936 بداعي التقدم بالسن بعد أربع سنوات فقط قضاها في الحكم، إلا أنه لا يستقيل بسبب خطأ وقع فيه، أو على خلفية احتجاجات شعبية مهما بلغت من قوة، ومهما كانت الأزمة عاصفة، وحدها الحكومات هي التي تدفع الثمن، ووحدها التي عليها أن تتحمل مسؤولية سوء أداء الرؤساء، وتكون كبش الفداء الذي يضحي به الرؤساء ليتفادوا توجيه اللوم لهم، أو المطالبة برحيلهم واستقالتهم هم، لا إقالتهم لحكومات لا تكاد تملك شيئاً من الصلاحيات مقابل الهيمنة شبه المطلقة لمنصب الرئاسة، وتملّكها لسلطات واسعة تجعلها حقيقة هي المسؤول الأول والأخير، بل الوحيد عمّا يجري في البلاد.الأسد لن يخرج عن هذه التقاليد. أزمة البنزين والغاز وغيرها لن يعترف أبداً أنها نتيجة سياساته الخاطئة والكارثية التي أدخلت البلاد في دوامة العنف الدائرة منذ سنوات، والتي تسببت بأكبر أزمة إنسانية في العصر الحديث، وهو سيحمّل الحكومة ورئيسها مسؤولية التقصير في تأمين الخدمات التي يطالب بها السكان، وهو سيقوم بالخطوة الغبية التقليدية نفسها في إقالة الحكومة "المسكينة" وتعيين بديل لها، لكن هل سيصل الغباء بالموالين له إلى حد الاقتناع بمسؤولية الحكومة عن هذه الأخطاء، وبالتالي السكوت والتوقف عن الغضب والشكوى التي سادت أجواء البلاد في الأيام الماضية؟ أم إن الموالين فهموا اللعبة هذه المرة وسيذهبون للمطالبة بمحاسبة الرئيس شخصياً عمّا آلت إليه أحوال البلاد؟ قد يكون الأمر مختلفاً هذه المرة، وقد نشاهد بشار في موضع الاتهام، والمطالبة باستقالته ومحاسبته، فما حدث قريباً في الجزائر والسودان يشجّع على ذلك.
اقرأ المزيد