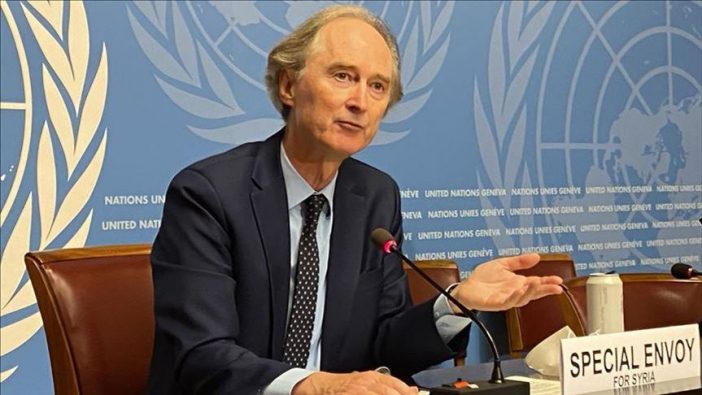ضربت الحرب في سوريا جميع قواعد النزاع التي يعرفها العالم، لا تكاد تميز اليوم بين الحلفاء والأعداء، ولا بين حليفين حقيقيين، أو عدوّين حقيقيين، ولا بين حليفين مستمرين، أو عدوّين مستمرّين، عاصفة مثالية متكاملة الأركان، لا تزال تجلب إليها عناصر مدمِّرة من كل حدَبٍ وصوب، أدوات النزاع البسيطة التي بدأت بها العاصفة كانت عبارة عن كلمات على جدران، واحتجاجات سلمية داخلية، كنسمة ريح حرّكت أوراق شجر ساكنة، ما لبثت أن اشتدت وتحوّلت إلى إعصار جارف لا يقف شيء في طريقه، ويضمّ في دوّاماته كل ما يقتلعه، ليزداد به قوة وتخريباً.الأطراف الداخلية والخارجية التي دخلت على خط الثورة السورية، كانت -بقصد أو بغير قصد-مدمّرة كعناصر هذه العاصفة.داخلياً من الناحية السياسية لم تحظَ الثورة بالتمثيل الذي تستحقه، وكان الضعف والتنافس السلبي السمة البارزة لها، وبقيت مشتّتة، ساهم في تقطيع أوصالها ظهور مجالس "وطنية" تمثل مكونات بعينها كردية وتركمانية وإيزيدية، تسعى لاقتسام السلطة بينها، ولم تجعل هدفها الوحيد إزالة النظام أولاً قبل كل شيء.من الناحية العسكرية: الحالة الفصائلية الغالبة على الجيش الحر، وفشله في التحول إلى جيش تحرير وطني، ونشوب اقتتال داخلي بين عدد من فصائله، تضعه إلى الجانب السياسي في التأثير السلبي.الأطراف الخارجية نوعان:الأولى التي تدخّلت إلى جانب النظام كانت تريد إنهاء النزاع لصالحه، وكسر إرادة الشعب السوري، وتركيعه واستسلامه، بدءاً من حزب الله اللبناني، مروراً بإيران، والمليشيات الطائفية الشيعية العراقية والأفغانية، انتهاء بالقوات الروسية النظامية.و الثانية التي وقفت إلى جانب المعارضة كانت تريد تقوية كفّتها لإجبار النظام على القبول بتسوية سياسية استناداً لقرارات مجلس الأمن، عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي، ووضع دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساسه.مع أن هذين الطرفين كانا يتحدثان عن الحل السياسي، إلاّ أن المفارقة كانت في أن الطرف الداعم للنظام فرض منطقه العسكري على الطرف الثاني، وجعل معادلة التفاوض ترتكز على ما يملكه كل من النظام والمعارضة على الأرض، فالمكاسب العسكرية التي يحققها النظام وصلت إلى طاولة المفاوضات، وصارت "الواقعية السياسية" المنصاعة لنتائج المعارك تتسلّل إلى صفوف المعارضة.المفارقة الثانية أن بعض الدول الداعمة والدول "المتفهّمة" للعمل العسكري للمعارضة، وبعد ظهور "تنظيم الدولة" و"جبهة النصرة"، بدأت بالضغط على الجيش الحر للتوقّف عن قتال النظام، وقصر عملياته لمواجهة هذين التنظيمين، وصل هذا الضغط إلى حد إلغاء برامج التدريب والتسليح بالكلية، وحين تدخّل التحالف الدولي بقواته في قتال "تنظيم الدولة وجبهة النصرة"، لم تعد الأراضي المحررة منهما إلى الجيش الحر، لكن تقاسمها النظام والمليشيات الكردية، بمعنى أن العمل العسكري للدول الداعمة للمعارضة كان يصبّ في مصلحة النظام.المجتمع الدولي يملك أدوات كثيرة قانونية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية، كانت كافية لتجنيبه الوقوع في هذا الفخ، وتقلل كثيراً من الخسائر الناجمة عن هذا النزاع بشرياً ومادياً، وتمنع ظهور مشكلة اللاجئين، وتقي ما حدث من تهديد لاستقرار المنطقة، وللأمن والسلم الدوليين.فمن ناحية القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، كان وقوع ضحايا من المتظاهرين السلميين أوائل أيام الاحتجاجات مشروعاً للتهديد بسَوق بشار الأسد ورموزه إلى محكمة الجنايات الدولية، ومع تصاعد العنف وقصف المدنيين العزّل بالبراميل، وحصار المدن وتدميرها، وعمليات التهجير القسري كان ينبغي إحالة ملف النظام إلى محكمة جرائم الحرب، ورفع الدعاوى ضده، بتهم انتهاك حقوق الإنسان، وجرائم الإبادة الجماعية، وإدراج أسماء المسؤولين عن الانتهاكات على لوائح العقوبات الدولية، مثل هذه الإجراءات كانت ستسهم في رفع درجة القلق والخوف من جانب النظام، وتخفيف حدة عنفه وجرائمه تجاه المناوئين له.ومن الناحية السياسية والدبلوماسية كان يجب نزع الشرعية عن هذا النظام، وطرده من المحافل الدولية كالجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات والمؤسسات التابعة لها، كما جرى طرده من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ووقف التعامل مع برلمانه الذي أيّد جرائمه، وإغلاق سفاراته، وطرد سفرائه، أو خفض مستوى التبادل الدبلوماسي معه، كان هذا سيظهره نظاماً منبوذاً مارقاً، يجعل الموالين له يعيدون حساباتهم في مصلحة استمرار هذا النظام حاكماً للبلاد.العقوبات الاقتصادية الدولية التي تستهدف أجهزة النظام ومؤسساته المشاركة في أعماله الوحشية، كتجميد الأصول المالية، وفرض القيود على التعاملات التجارية، وحظر توريد السلاح، كانت ستساهم في إنهاك النظام اقتصادياً، بحيث يعجز عن الإنفاق على جيشه وآلته الحربية العاتية.بعيداً عن نظرية المؤامرة التي يصعب الحديث عنها لتعذّر اتفاق كل هذه الأطراف عليها، لكن يمكن الإحالة إلى أخطاء وقعت في مراحل مبكرة، ولم تتم معالجتها، بل صارت كمبادئ حاكمة يصعب التفكير خارج إطارها.ضمن المعطيات الحالية في "إدارة الأزمة" لا يوجد حل سياسي لا في جنيف ولا في أستانا ولا من سوتشي، ولا عبر تشكيل لجنة دستورية، أو وضع أطر وضوابط للعملية الانتخابية، كما تقترح سوتشي، وورقة الدول الخمس.هل فات الأوان على ذلك؟ لا، لم يفت الأوان، لكن يجب على المعارضة السياسية قبل غيرها، وبالأخص هيئة التفاوض أن تطلب من الدول الداعمة للثورة، وبما لها من تحالفات ونفوذ على غيرها، أن تعيد النظر في سياساتها، وأن تعمل على تفعيل هذه الأسلحة جميعاً إلى جانب العمل العسكري، فاستمرار العمل بالأدوات المستخدمة الآن فقط، يعني استمرار العاصفة التي لن تهدأ.
اقرأ المزيد