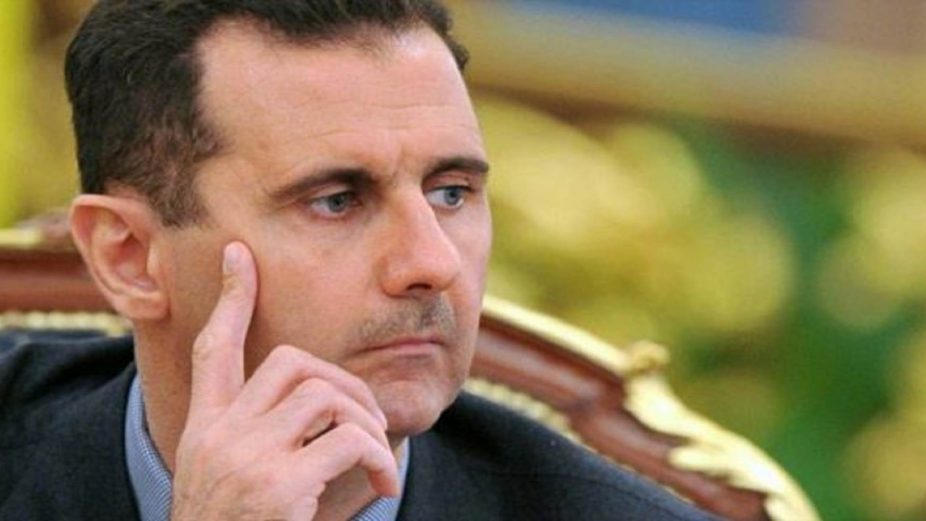مركز الجسر للدراسات...
( ومن قال إن الأسد لم يسقط ؟ ) .. قد يبدو هذا العنوان غريباً عند من يعتبر مسألة سقوط نظام أو حاكم تتعلق فقط بمغادرة منصبه تحت سطوة احتجاجات شعبية أو انقلاب عسكري، لكنَّ الذين يرون السقوط هو انعدام المقدرة والعجز عن إدارة الدولة؛ فإن لهم رأياً مختلفاً تماماً؛ إذ يرى هؤلاء أن الثورة وإن لم تحقّق غاياتها البعيدة، إلا أنها استطاعت إنجاز شيء ما مع أول صراخ هتفت به حناجر المتظاهرين: الشعب يريد إسقاط النظام.. نعم .. لقد سقط نظام الأسد فعلياً وظهر على شكله الأصلي كعصابة تدير البلاد بعقلية قُطّاع الطرق، وما يظهر اليوم ليس سوى جثة أراد لها الداعمون أن تبقى بمظهر الصمود إلى أن يحققوا غاياتهم، فإذا وصلوا إلى ما يريدون سحبوا تلك العصا التي تسند نظام الأسد، فيخرُّ جثةً هامدة.تحاول مراكز صنع القرار الغربية بالإضافة إلى مراكز الأبحاث والدراسات ترويج فكرة مفادها أن الأسد "انتصر في معركته" وأنه على وشك إعلان فوزه بعد سبع سنوات من الثورة الشعبية في سوريا.ولا توفّر هذه المراكز جَهداً في تَعداد وشرح مُجمل الأسباب التي أدت إلى "رُجحان كفة الأسد" على جميع معارضيه، بل وتذهب بعض الآراء إلى أبعدَ من ذلك حين تتحدث عن الطريقة التي سيُعيد فيها النظام إعمار سوريا وعن عودة اللاجئين، وعن دول عربية وغربية باتت تطلب التنسيق معه في الجهر أو في الخفاء، وفق ما أفاد به وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قبل أيام.تعتمد هذه الفكرة عموماً على مبدأ "السيطرة على الأرض"، ثم على الأجواء السائدة دَولياً وتغيُّر النظرتين الأمريكية والأوربية من الحرب في سوريا، أو على "فشل" المعارضة السياسية والعسكرية في تحقيق اختراق لمصلحتها على الأرض أو في محافل المفاوضات.يسمع السوريون خارج البلاد وداخلها كل هذه الآراء باهتمام، وتختلف ردات فعلهم تُجاهها بين واقعٍ في شِباك هذه الرؤية، أو مُنكر لها جملة وتفصيلاً، ولكل من الفريقين حجتُه، فالفريق الأول -الذي يحوي أصلاً مؤيِّدي النظام أو من يُسمَّون بالفئة الرمادية- يرى أن ما جرى خلال الأعوام الماضية حرب فعلية بين معسكرين متكافئين، وأن الشعب مجرد ضحية لهذه الحرب التي تميل كفتها بشكل واضح لصالح الأسد وحلفائه. بينما يرى الفريق الثاني -في المناطق المحرّرة أو دول اللجوء- أن مسألة "انتصار الأسد" بعد قتله مليون شخص وتدمير نحو 60 % من البلاد، هي جزء من الحرب النفسية والإعلامية التي يتعرّضون لها منذ اليوم الأول لاشتعال الاحتجاجات عام 2011. ولا يمكننا إنكار أن جزءاً لا بأس به من "جمهور الثورة" بدأ بالتسليم لهذه المقولة، معتبراً أن الثورة بمعناها الأوّلي انتهت، وأن سوريا تعود إلى حكم عسكري أشدَّ وطأة مما كانت عليه قبل اندلاع الثورة.دعونا نقول قبل كل شيء إن الترويج لفكرة "انتصار الأسد" لا تبدو بريئة هذه الأيام، ولا سيما أن بشار نفسه تحاشى الحديث عن "نصر" في كلمته الأخيرة 20 آب 2017، ثم إن الحكم بالنصر أو الهزيمة استناداً إلى واقع السيطرة على الأرض والجوّ الدولي السائد ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً إذا علمنا أن النظام فقد أكثر من 85% من سوريا منذ بداية الثورة إلى نهايات 2015، ولم يعلن أحد حينها أنه هُزِم، كما إن المجتمع الدولي - عدا معسكر روسيا وإيران والصين – لم يحِد عن فقدان الأسد شرعيته ووجوب رحيله بشكل فوري، وأتوقع أن جملة " أيام الأسد معدودة" لا تزال تشكّل هاجساً لدى الأسد وحلفائه على حدّ سواء.على أيّة حال، ورغم الضخّ السياسي والإعلامي الذي يريد تثبيت مقولة "انتصار الأسد"، إلا أن أطرافاً لا يُستهان ترى خلاف ذلك، ولا تعتبر مجرد حفاظه على الكرسي أو هزيمة المعارضة في بعض المناطق من دواعي الانتصار في شيء، بل إن ممثل هيئة الأركان المشتركة الأميركية شكك بشكل صريح قبل أيام بقدرة قوات الأسد على الاحتفاظ بالمناطق التي استعادتها غرب سوريا بغطاء جوي روسي. مؤكداً "أن الأسد لا يستطيع الحفاظ على مكاسبه العسكرية".إنَّ نظرة سريعة لِما كانت عليه سوريا قبل شهر آذار 2011 واليوم، تُشير بلا التباس إلى أن الأسد أقربُ إلى الهزيمة من الفوز، ( وإن لم تنتصر المعارضة )، فالحاكم الذي كانت أذرعه الأمنية تتحكم بجميع التفاصيل لم يعُد في واقع الأمر سوى ورقةٍ سياسية تتجاذبها الأطراف الداعمة فيما بينها.يعرف السوريون جيداً أن مفاصل صنع القرار في نظام الأسد تجاوزت دمشق، وأن أركان النظام – بما فيهم بشار – لا يمكنهم اتخاذ أي قرار لا يوافق عليه الروس والإيرانيون الذين يكررون دائماً أنهم " أنقذوه من السقوط" ، ولم يكن كلام لافروف حول أن روسيا حمت دمشق من السقوط "بيد الإرهابيين" سوى رسالة للأسد.. فهل يمكن لنظام ارتهن بكل تفاصيله لأجندة من أنقذوه أن يوصف بالمنتصِر؟!الروس قالوها مراراً .. نحن لا نتمسّك ببشار، وهم لم يقولوها عبثاً بل إن موسكو تريد بشكل فعلي من يحفظ لها مصالحها في سوريا، وألا تغادر الشرق الأوسط بلا رجعة بسقوط الأسد. وكي لا يكون الحديث موجهاً بدافع عواطفَ أو تمنّيات، فإن السطور القادمة تسرد أسباباً موضوعية تدعم فكرة أن الثورة حققت هدفها بإسقاط الأسد، وإن لم تحظَ -حتى اللحظة على الأقل- بنيل ما خرجت لأجله كاملاً.أولاً : الأزمة الاقتصادية :ربما كان إسقاط الأسد اقتصادياً هو السيناريو المفضل لدى الغرب، ولذلك بدأت العقوبات في وقت مبكر بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية.ورغم كثرة الأطراف التي فرضت العقوبات ورغم كثرة الأطراف والجهات والشركات والمؤسسات التي تعرضت لتلك العقوبات؛ إلا أن الأثر المباشِر على نظام الأسد لم يكن كافياً لدفعه إلى طاولة التفاوض، ولاسيما بعد الشرايين الإيرانية والروسية التي ضخّت الأموال بشكل سخيّ في عروق النظام المريض، إضافة إلى الالتفاف على العقوبات.لكن امتداد سنوات الحرب والاستنزاف الذي أصاب اقتصاد الأسد، وهروب رؤوس أموال ضخمة من البلاد والانقطاع الكامل في باب الاستثمار وعائدات السياحة، كل ذلك ساهم في هبوط قيمة الليرة السورية إلى أكثر من عشرة أضعاف خلال أكثر من ستة أعوام، وأصبحت الهوة كبيرة جداً بين غلاء الأسعار ومتوسّط دخل الفرد. وما طرحُ فئات نقدية كبيرة ( مثل فئة 2000 ) إلا إقرار بمزيد من التضخّم الذي ينعكس بدوره على المواطنين، إذ ارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 80% من سكان سوريا، وأصبح أكثر من 90% منهم يعيشون على التحويلات المالية الخارجية.إذن ..رغم الدعم الذي تلقّاه نظام الأسد، إلا أنه دعم ساعده على عدم السقوط اقتصادياً؛ وليس من النوع الذي يمكن أن يجعل النظام يقف على قدميه، والدليل على ذلك أنه تجاهل طلبات برفع الرواتب والأجور لسدِّ الفرق الهائل بين الدخل والإنفاق.وضع نظام الأسد عينه على أموال ما يسمى "إعادة الإعمار" لعله يستفيد منها في تحسن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد؛ إلا أن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة يرفضان حتى هذا الوقت التعاون معه في هذا الملف، ما يُفقده باباً كان يمكن أن يُسند عجزه المتواصل.المقالة ليست اقتصادية بالتأكيد فلهذا الميدان أهله، والمقالات التي تناولت الإشكالية الاقتصادية لدى نظام الأسد كثيرة جداً؛ لكنها إشارة وإضاءة صغيرة وتساؤل مهم: هل يمكن لنظام يعيش على المساعدات ويعيش الغالبية الساحقة من شعبه على المساعدات أن يكون على ما يرام ؟؟ثانياً: غياب "السيادة العسكرية والأمنية والسياسية":إذا كان الاقتصاد هو الركيزة الأولية في بناء أي نظام، فإن المقدرة العسكرية على حماية الدولة تأتي في المقام الثاني.مثلما تلقّى نظام الأسد إمداداتٍ مالية أجّلت سقوطه وحمته من التهاوي سريعاً، فإن الأمر نفسه حصل في الجانب العسكري، إذ انهار ما كان يعرف بـ"الجيش العربي السوري" خلال عام أو عام ونصف من بداية المواجهات المسلحة، ما جعل الأسد يعتمد على مليشيات محلية أو مليشيات طائفية متعددة الجنسيات أو على جيوش الدول الحليفة. وفي كل طرف من هذه الأطراف تبرز إشكاليات عدة، نحاول إجمالها فيما يأتي :1- إشكالية الاعتماد على مليشيات محلية : بعد تفكُّك المؤسسة العسكرية التقليدية بسبب الانشقاق أو الفرار أو القتل، عمِدت المناطق الموالية للأسد -ولا سيما في مسقط رأسه بالساحل السوري- إلى إنشاء مليشيات مسلحة تسد النقص الحاصل على جبهات القتال.وعلى الرغم من الفعالية التي جناها الأسد من هذه الخطوة إلا أن فيها سلبياتٍ كبيرة بعضها ظهر بالفعل وربما يظهر بعضها بشكل أوضح في وقت لاحق.في الوقت الذي قامت فيه الثورة السورية لم تكن طائفة الأسد مثلاً في أحسنِ حالاتها، إذ يعاني قسم كبير من الطائفة العلوية من التهميش والإقصاء والفقر، ولعل هذا الأمر كان ترتيباً مقصوداً منذ عهد حافظ الأسد لإجبار هذه الطائفة على الانخراط في السلك العسكري، ولا يمكن أن نفهم أن الدفاع المستميت للطائفة العلوية عن الأسد جاء من قناعة واحترام لما قدّمه لهم، بل تُجمع الآراء على أن حرب الطائفة إلى جانب الأسد إنما يأتي من باب الدفاع عن الوجود.. نعم هي حرب وجودية بالنسبة لهم، ولا سيما أن النظام زرع في عقولهم إشكالية طائفية تقول لهم إنهم سوف يزولون من الوجود إن لم يكونوا تحت حماية الأسد.ما حصل أن اعتماد بشار على تلك المليشيات المسلحة عكَسَ القضية، فجعله هو تحت حمايتها بدل أن تكون تحت حمايته، ما يجعل هذه المليشيات تتحول مع مرور الزمن إلى "عصابات مسلحة" لا يمكن أن تسكت إن لم تحصل على ما تريد، ويستحيل ضبط سلاحها داخل المدن أو خارجها. وهذا ما يضع النظام أمام إشكالية تحتاج وحدها إلى سنوات وسنوات لحلها، فالمليشيات ترى – كغيرها من الأطراف التي أنقذت الأسد – أنها صاحبة فضل في بقاء النظام، ولها الحق الكامل في الحصول على ما تريد، وستقوم بالتالي بعرقلة أي محاولة من النظام لتقنينها أو ضبطها بعد اعتيادها على نهج القتل و"التشليح" و"التشبيح".2- إشكالية الاعتماد على مليشيات طائفية متعددة الجنسيات : ربما تنطبق كثير من البنود التي سردناها في الفقرة السابقة على المليشيات الشيعية متعدّدة الجنسيات، فهي ترى كغيرها أنها أنقذت الأسد من السقوط، ولا بد أن يواجه الأسد معها إشكالات أقوى من تلك التي تصنعها المليشيات المحلّية، فالمليشيات الشيعية على اختلاف جنسياتها ليست موضع ترحيب حتى من الموالين للأسد، والنهج الذي يتخذه العناصر العراقيون أو الإيرانيون أو الأفغان أو الباكستانيون يُعد على العموم نهجاً غريباً بالنسبة للمجتمع السوري، ما يجعل اندماج تلك المليشيات صعباً للغاية إن لم يكن مستحيلاً.أمام نظام الأسد خياران للتعامل مع تلك المليشيات، الأول هو إخراجها بالقوة من المناطق التي تنتشر فيها، وهذا ما لا يطيقه النظام ولا يمكن أن يفكر فيه، أما الخيار الثاني فهو الاستسلام لها والتعامل معها على أنها "أمر واقع"، وبالتالي لن يكون للأسد أي سطوة عليها، وستقوم بالدخول في مضمار القرصنة ومحاولة إثبات الذات، ولا يستبعد نشوب خلافات مستقبلية بينها وبين المليشيات المحلية.على كلتا الحالتين يظهر نظام الأسد عاجزاً عن حلّ تلك الإشكالية العويصة، فلو كان لديه قدرة على التعامل مع تلك المليشيات لما جلبها واعتمد عليها أساساً.3- إشكالية الاعتماد على جيوش "دول صديقة": هنا الإشكالية الأقوى ..لأن دولاً كإيران وروسيا دخلت الحرب السورية بكل ثقلها لن ترضى إلا بتحقيق ما تريد من مصالح، وقد بدأت هاتان الدولتان فعلياً جني ثمار تدخلهما حتى قبل نهاية الحرب، فكيف سيكون الأمر إن انتهت الحرب؟ .. الأسد أمام هاتين الدولتين ليس له أي قرار عسكري أو أمني، ومن نافلة القول أن روسيا هي من تولت حماية بشار على المستوى الشخصي.تسيطر روسيا اليوم على قواعد بحرية وبرية وجوية في قلب مناطق الأسد، وبعض المقرات العسكرية الروسية يُمنع كبار ضباط الأسد من دخولها، ولا يمكن لهذا النظام في أفضل أحلامه وأكثرها وردية أن يظن نهاية الحرب نهايةً لهذا التدخل، فروسيا خططت لتدخل قد يطول عشرات الأعوام، ولعل المثال الأقرب أنها استحوذت على قاعدة بحرية في طرطوس لمدة 49 عاماً قابلة للتمديد 25 عاماً إضافية في حال رضا الطرفين!أما إيران فالأمر معها لا يقل تعقيداً، بسبب تاريخ العلاقات الطويل بينها وبين نظام الأسد الأب والابن، وهي من الآن تسرد بين الحين والآخر قائمة طويلة بعدد قتلاها في سوريا، في رسالة واضحة تقول إيماءً إن هذه الدماء الإيرانية التي دافعت عن الأسد لها ثمن، والثمن لن يدفعه بالتأكيد من يخسر الحرب، الثمن سيدفعه من يُفترض أنه "فاز بالحرب"، سيدفعه على شكل تنازلات عسكرية وأمنية واقتصادية وثقافية، وكيف ننسى ذلك المسؤول الإيراني الذي قال على الملأ إن سوريا هي ولاية إيرانية؟؟بالنسبة لروسيا وإيران، لن يكون بشار الأسد سوى زبون استطاع الحفاظ على منصب اسمي، بينما دفع لهذا المنصب ثمناً يلتصق عادة بالمنصب، ولا يمكن أن يكون المنصب منصباً لولاه، لقد دفع لمن أنقذوه ما كان يدعوه "سيادة وطنية" فلا هو قادر على حرمان كل هذه الأطراف من مكاسب حققتها، ولا هو قادر على مواجهة دول قالت ألف مرة إنها صاحبة الفضل في بقائه وإنقاذه، والمنطق يقول إن من اعتمد في بقائه على غيره فهو حكماً "غير موجود".نؤكد ما قلناه بداية، بشار الأسد سيكون - بعد الحرب – ورقة مساومة لا أكثر، فوجوده كان ضرورياً للحفاظ على مكاسب "الأصدقاء"، أما وقد أصبح الأصدقاء هم أصحاب القرار والوجود على الأرض، فلا حاجة أصلاً للدفاع عن بقائه في المنصب، إذ تستطيع الأطراف التي تُمده بأسباب البقاء أن تصنع لها شخصية ثانية، يضمن بقاء مصالحها؛ ولا سيما أن بشار الأسد وكيل احترق أخلاقياً وسياسياً وعسكرياً وشعبياً، ولا يمكن الوصول إلى "سوريا ما بعد الحرب" بوجوده.يبرز الجانب الآخر من إشكالية "السيادة" لدى نظام الأسد، في أن البلاد تحولت فعلياً إلى ميدان لإقامة مناطق النفوذ والقواعد العسكرية الأجنبية، إذ تسيطر الولايات المتحدة وحلفاؤها على معظم محافظتي الحسكة والرقة ويفترض أن تكون الضفة الشرقية من محافظة دير الزور كذلك تابعة لهم، وفي الشمال يبدو النفوذ التركي آخذاً بالامتداد بتفاهمات مع الروس، بينما تضع روسيا يدها على قواعد برية وبحرية وجوية تغطي كافة الأراضي التي يفترض أنها واقعة تحت سيطرة الأسد.ثالثاً : الفساد المالي والإداري : لعل الفساد الإداري جانب يرافق عادة الدول الفاشلة، فعندما تضعف سطوة الدولة وتنهار قدرتها على ضبط الأمور الداخلية يبرُز الفساد الإداري عاملاً يساهم في زيادة فشلها ومضاعفة عجزها.المميز في نظام الأسد أنه نظام فاسد قبل الثورة وقبل الحرب وقبل الفساد بحدّ ذاته، وبدل أن تحثَّه الثورة على القيام بإصلاحات فعلية في هذا الملف الخطير، قفز مؤشر الفساد في سوريا إلى مستويات عالية، مع انشغال الأسد بالقتال، وتفرغه لتدمير المدن فوق أهلها؛ ما جعل أي مسؤول -مهما كان حجم منصبه أو المجال الذي يديره- يضع نصب عينيه الاستفادة أكبر قدر ممكن من فترة وجوده في المنصب، يشجّعه على هذا شعور بأن النظام الذي يخدمه يمكن أن ينتهي في أي لحظة.الأسد يعرف جيداً مستوى الفساد الذي ينخر نظامه منذ عقود، ويبدو أنه صمَتَ عن موجة كبيرة من الفساد خلال سنوات الحرب لعدة أسباب، ويبدو كذلك أنه استخدم "محاربة الفساد" دعاية داخلية وخارجية خلال الأشهر الأخيرة.إن محاسبة مسؤولين من الصف الثاني أو الثالث في هرم النظام، ستعطي انطباعاً أن النظام قادر على الإمساك بتفاصيل الحكم، وهذا ما يجمّل صورة حكومته أمام الرأي العام.مسؤولون كثر مارسوا الفساد الإداري والمالي والأخلاقي كذلك، وقد وجد نظام الأسد مادة دسمة في معاقبتهم أو عزلهم، ليوحي للرأي العام أنه يقوم بواجبه في محاربة الفساد، بينما تشير الوقائع إلى أن الفساد في نظام الأسد هو "تكتيك ممنهج" يبدأ باختيار الأشخاص الفاسدين أصلاً، وينتهي بمعاقبتهم كي يكونوا هم كبش الفدا للفساد الأكبر المتمثل بشخصيات تحتل رأس الهرم في تركيبة النظام.هذه السياسة التي يتبعها نظام الأسد يستطيع من خلالها التهرب من المسؤولية أمام الشعب – الذي لا يستطيع أصلاً أن ينتقد -، وإيهامه أن تغييراً ما يطرأ في بنية النظام عن طريق تشديد المحاسبة، لكن هذا الأمر أوصل سوريا إلى احتلال مراكز متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية، حيث ارتفعت نسبة الرشاوي خلال سنوات الحرب عشرة أضعاف على ما كانت عليه عام 2010، وأكدت "وزارة المالية" في إحصائية لها أن حجم الفساد المكتشف في 19 شهراً فقط يقدّر بخمسة مليارات ليرة سورية !.إن فساداً تراكم خلال عقود وقفز إلى مستويات إضافية في فترة الحرب لا يمكن أن تزول آثاره خلال عقود من الزمن، ولا سيما إذا ربطناه مع بند "فقدان السيادة" الذي يجعل نظام الأسد غير مؤهّل لكبح جماح الفساد، سواء أكان مصدره جهات داخلية دعمت بقاءه أو جهات خارجية حمته من السقوط.نعم.. سيقوم الأسد بغية تجميل صورته بملاحقة شخصيات صغيرة لا قيمة لها، ويدَّعي صرامة قبضته في محاربة الفساد، بينما سيبقى هذا الفساد داءً عضالاً، كان سبباً من أسباب قيام الثورة، وسيبقى عامل احتقان وفشل ينخر عظم النظام الذي أوهته الحرب.رابعاً : الملاحقة القانونية والسقوط الأخلاقي:في آذار - مارس 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير؛ بسبب "الاشتباه" بأنه "مسؤول جنائياً" عن عمليات قتل وتعذيب وتهجير قسري ضد جزء كبير من السكان المدنيين في إقليم دارفور.بغضّ النظر عن جدوى الحكم ومصداقيته، إلا أن عمر البشير مطلوب للمحاكمة، ومطلوب من كل دولة يحل فيها أن تعتقله بتهمة "مجرم حرب"، وهذا ما سيحل حتماً ببشار الأسد بعد أن تضع الحرب أوزارها، فالجرائم ضد الإنسانية لا تموت بالتقادم وفق القانون الدولي، وما مثال رئيس صرب البوسنة "رادوفان كراديتش" ببعيد، فقد تم إيقاف هذا الجزار بعد فرار استمر 13 عاماً لمسؤوليته عن مذبحة "سربرينيتشا" التي قتل فيها نحو ثمانية آلاف مسلم.بشار الأسد اليوم مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن مقتل نحو مليون سوري، ويأتي اسمه مع عدد من مسؤولي نظامه في قوائم عقوبات أوربية أو أميركية يرى بعض المراقبين أنها لا تأخذ فقط طابعاً اقتصادياً، لكن طبيعة الصراع المعقّد في سوريا فرضت طيّ صفحة الطابع القانوني حالياً.إن بشار الأسد سقط عملياً مع أول رصاصة أطلقها على المتظاهرين، لأن المجتمع الدولي يتعامل عادة بمبدأ "سُلّم الأولويات" والأولوية اليوم هي للقضاء على "الإرهاب" الذي صنعه الأسد أصلاً لتجميل صورته الإجرامية، فإذا ما زالت "ذريعة الإرهاب"، سيحين وقت الحساب.نظام تتهمه المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم حرب لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية لا يمكن أن يكون قابلاً للعيش، بل المؤكد أن داعميه أنفسَهم سوف يتخلّون عنه عند انتهاء دوره كما ذكرنا سالفاً.
اقرأ المزيد